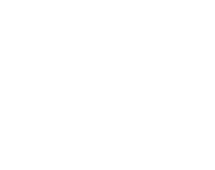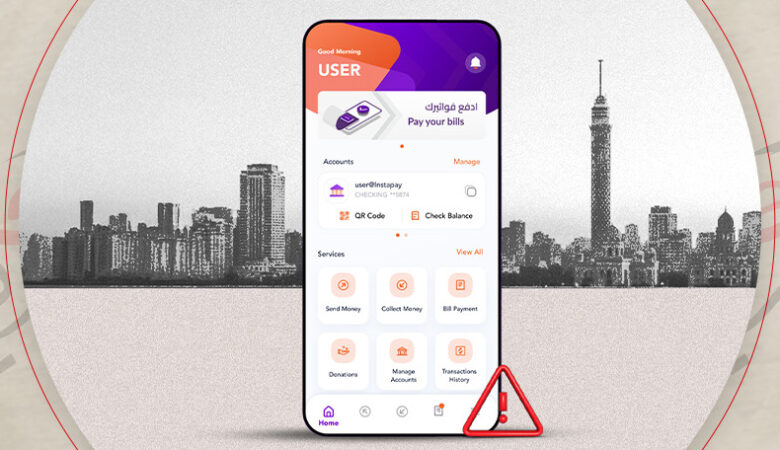في كل صيف، تتحوّل شواطئ مصر إلى مرآة للفوارق الاجتماعية. على امتداد الساحل الشمالي، تتجاور صورتان متناقضتان: مواطن عادي يخطط بعناء ليوم واحد على شاطئ شعبي، وطبقة صغيرة تنفق عشرات الآلاف في ليلة واحدة داخل حفلة أو فيلا فاخرة. مشهدان متوازيان، لكنهما يكشفان انقسامًا اجتماعيًا آخذًا في الاتساع: ‘‘الساحل الطيب والساحل الشرير‘‘.
في مشهد “الساحل الطيب”، يقف آلاف المصريين على أبواب البحر بالحسابات الدقيقة. رسوم دخول شاطئ خاص تتراوح بين 200 و300 جنيه، وغرفة فندقية متواضعة لا تقل عن 1500 جنيه لليلة. كثير من الأسر تكتفي بيوم أو يومين بالكاد، أو تفضّل شواطئ الإسكندرية ورأس البر الأقل تكلفة، وربما يستاء أحدهم عندما يجد ارتفاعًا في سعر النظارة الشمسية أو العوامات.
القصة لا تقف عند حدود الزائرين، فالمصايف بالنسبة لآلاف آخرين هي موسم رزق وحيد. على الأرصفة تنتشر بسطات الملابس والعوامات والنظارات، يبيعها شباب يعوّلون على هذا الموسم لتأمين دخل يعوض شهور البطالة.
هؤلاء العمال الذين ينتظرون حر الصيف للسعي في أرزاقهم، لا مكان لهم في الأوراق الرسمية، أو في التأمينات، أو قواعد بيانات وزارة القوى العاملة. فـ”رزق المصيف”، كما يسميه العاملون فيه، ينتمي إلى “اقتصاد الظل” الذي يتحرك خارج المظلة الرسمية، من دون عقود، أو غطاء صحي أو اجتماعي، أو حماية قانونية، على الرغم من أن هذا النوع من النشاط الاقتصادي ينتمي إلى فئة “الاقتصاد غير الرسمي، والذي أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن نسبته في مصر تتراوح بين 30% إلى 40% من الناتج المحلي الإجمالي.
لم يقف الأمر عند ذلك، فبينما تمتلك مصر أكثر من ألفي كيلومتر من السواحل على البحرين المتوسط والأحمر، ومئات الكيلومترات الإضافية على البحيرات، مما يجعلها نظرياً في طليعة دول العالم من حيث نصيب الفرد من البحر، لكن الواقع يخبرنا أنه بسبب سياسيات حكومية تحول المصريون إلى شعب من أفقر الشعوب في حصة الواحد منا من البحر.
فمئات الكيلومترات على البحر الأحمر، مثلاً، تم إغلاقها بأسوار الشركات العسكرية، أو قرى الأثرياء الحصرية، أو حتى مزارع توليد الطاقة بالرياح. أما في الإسكندرية، فقد تم استبدال “الحق في البحر” بمئات المطاعم والكافيهات التي أغلقت الكورنيش على المواطن العادي. هذا “الإغلاق” لا يقتل الترفيه فقط، بل يقتل فكرة “اللانهاية” في خيال الإنسان، ويجعله يشعر أنه محبوس داخل أسوار، لا يرى أفقاً، ولا يعرف ما يجري وراء الجدران. إنه يسرق من الأجيال القادمة حقها في البحر، كعنصر أساسي في تكوين الوعي والخيال والانتماء للمكان.
وعلى الجانب الآخر، يقف “الساحل الشرير”. هنا، أسعار لا تمت لواقع الأغلبية بأي صلة. حفلة عمرو دياب الأخيرة تراوحت تذاكرها بين 4 آلاف و17 ألف جنيه، وبعض فئات الـVIP وصلت إلى 20ألف جنيه. في مهرجانات العلمين، قد تصل تكلفة طاولة واحدة إلى 75 ألف جنيه لخمسة أشخاص، و150 ألفا لثمانية أشخاص.
أما إيجار الفيلات الفاخرة فيتجاوز 30 ألف جنيه لليلة واحدة، ليتحول البحرإلى مجرد خلفية لاستعراض القوة الشرائية، بينما الترفيه الذي هو ضرورة بشرية وحقا إنسانيا للسلامة النفسية، يصبح إلى مناسبات حصرية لا مكان فيها إلا لمن يملك.
وسط هذه الفوارق، تعلن الحكومة أن إشغال الفنادق تخطى 80% وأن إيرادات السياحة ارتفعت 22% في النصف الأول من 2025 لتسجل نحو 8 مليارات دولار.
أرقام براقة تعكس صورة انتعاش سياحي على الورق، لكنها لا تجيب عن السؤال الأهم: ما نصيب المواطن العادي من هذا الانتعاش؟. متوسط إنفاق أسرة مصرية متوسطة على المصيف – إذا استطاعت – لا يتجاوز 5 إلى 7 آلاف جنيه، وهو ما يعادل تكلفة ليلة واحدة فقط في بعض حفلات الساحل أو ربع تكلفة إيجار فيلا فاخرة لذات الليلة.
وتدهورت مصايف النقابات ونمط القرى السياحية التعاونية، بينما تواصل الدولة التباهي بأرقام السياحة، التي يتمتع بها الأجنبي ويحرم منها ابن البلد، ليظل السؤال معلقاً: إلى متى يمكن أن يستمر هذا الازدهار على الورق، بينما يتعمق الانقسام على أرض الواقع، ويتحول البحر والنهر إلى حكر على فئة، يُحرم من الإطلال عليه عامة الشعب؟
أضف تعليقك