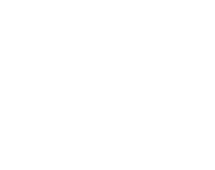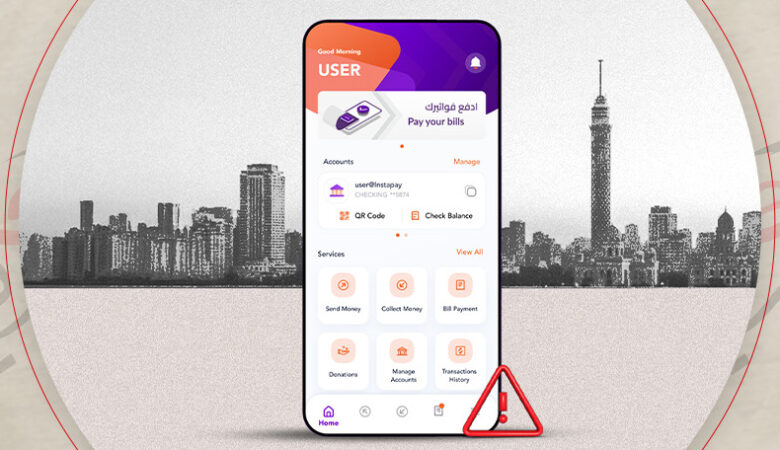خلال أسبوع واحد رُصدت 4 حالات وفاة مرتبطة بالاحتجاز: ثلاثٌ خلال 24 ساعة ورابعة قبلها بأيام. في قسم ثانِ شبرا الخيمة تُوفّي الموظف وليد أحمد طه بعد احتجازه على خلفية مشادّة جيران؛ تقول أسرته إن ضغوطًا مورست عليه للتنازل، ثم انتهى الأمر بوفاته داخل الحجز. وفي قسم المنشية بالإسكندرية سُجّلت حالتان متتاليتان لوفاة محتجزين: رمضان السيد حسن، ثم محمد أحمد سعد المعروف بـ(الصاوي). أمّا في قسم الهرم فسبقت هذه الوقائع بأيام وفاة محتجز آخر، وتحقق النيابة في الملابسات. روايات الأسر وشهود محلّيين تتحدّث عن إهمالٍ طبي وضغوطٍ للتصالح، بينما لا تزال الروايات الرسمية الكاملة والتحقيقات المعلنة ناقصة أو قيد المتابعة.
ولكن هل هي حالات فردية؟.. ليست كذلك مع الأسف، في 2020 مات إسلام وشهرته “الأسترالي” عقب توقيفه في المنيب بالجيزة، وقبله، قُتل الصعيدي الجدع عويس الراوي في الأقصر بطلقات في الرأس أطلقها عليه أحد الضباط عقب مشاجرة لفظية بينهما. وفي 2023 توفّي المحتجز محمود عبدالجواد داخل مركز شرطة نبروه وسط اتهامات بالتعذيب، وأمثلة أخرى كثيرة لحالات قتل خارج إطار القانون.
المشهد يتكرر: مواطن يُحتجز، أسرة تبحث عنه، روايتان تتصارعان، الأهل يتهمون الشرطة بتعذيب الضحية حتى الموت، والشرطة تزعم موت الصحية لقصور في الدورة الدموية.
بيان مقتضب ينتظر «الطب الشرعي»، وضجيج على السوشيال سرعان ما يخفت بلا إجابة. المشكلة ليست في واقعة بعينها؛ القصة أن الحكاية نفسها تُعاد بتفاصيل مختلفة: أسماء جديدة، قسم جديد، نفس النهاية المفتوحة. هكذا تتحول الحوادث الفردية إلى نمط يلتهم الثقة الهشة بين الناس ومؤسسات الأمن.
ما الذي جعل هذا الواقع البائس الذي تُنتهك فيه حرمات المواطن أمرًا واقعًا أصبح المصريون الغلابة يحيون فيه ليلًا ونهارًا؟
إنه غياب المحاسبة، وعدم تفعيل القوانين، رغم أنها قوانيت تأسست على تمكين كامل للشرطة وقوات الأمن بحجة مجابهة الإرهاب فإذا بنا بعد ١١ عامًا من الدستور الجديد، نجد أن الإرهاب هو المواطن البسيط: عويس الراوي ووليد أحمد وغيرهم من الموظفين والعمال والفلاحين.. هل هؤلاء هم الإرهاب؟ أم الإرهابي هو السايس الذي يعمل في نادي القضاة وتعدى عليه قبل أيام في واقعة رأيناها جميعا، أحد ضباط الشرطة بسبب أنه رفض يركن عربية “الباشا”؟
«دولة الضبّاط» ليست شعارًا لتنفيس الغضب، بقدر ما هو وصف لواقعٍ يسمح لثقافة الإفلات من المساءلة أن تسود.
لقد أدى القمع الذي طال قطاعات واسعة من المصريين دون حساب، إلى التذكير بما وعد به الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقت أن كان وزيرا للدفاع في ٢٠١٣ قائلا “الظابط اللي يصفي عين واحد ولا يعمل حاجة مش هيتحاسب خلاص” فإذا بنا بعدها نعيش في دوامة من المظالم لا نهاية لها.
يحتاج المصريون إلى قواعد تحمي المواطن والضابط معًا. ولذلك ثلاثة مفاتيح واضحة:
- شفافية فورية في كل واقعة وفاة/إصابة داخل الحجز: خط زمني من لحظة الضبط، أسماء النوبتجية، وتمكين الأسرة ومحاميها من الاطلاع على الكاميرات.
- نظام تصوير إلزامي في غرف الاستقبال والممرات وغرف التحقيق، بذاكرة تخزين لا تُمسح قبل مرور مدة قانونية، وجهةٍ محايدة تحفظ النسخ.
- طب شرعي مستقل وإحصاءات دورية عن وفيات وأمراض الحبس تُنشر للعموم، مع تدريب ملزم على بروتوكولات منع التعذيب والرعاية الطبية وحقوق المحتجز.
هذه ليست رفاهية «حقوقية»؛ هذه أدوات إدارة دولة.
الدولة التي تريد أن تُصَدَّق روايتها، لا بد أن تُمكّن الناس من التحقق منها. وإلا سنبقى ندور في الحلقة نفسها: حادثة، ضجيج، صمت.. وثقة تنقص.
الأمن القوي هو أمنٌ يمكن مساءلته، والعدالة التي تُرى وتُوثّق هي وحدها التي تُشفي الجرح العام.
حين تنتصر القواعد على المزاج، نغادر منطق «دولة الضبّاط» إلى منطق دولة القانون – حيث لا يموت مواطن بلا إجابة، ولا يُتهم ضابط بلا دليل، وحيث تعود الثقة ممكنة.