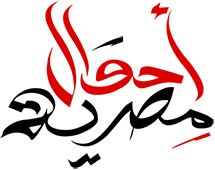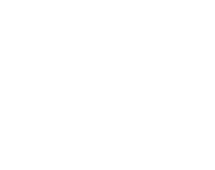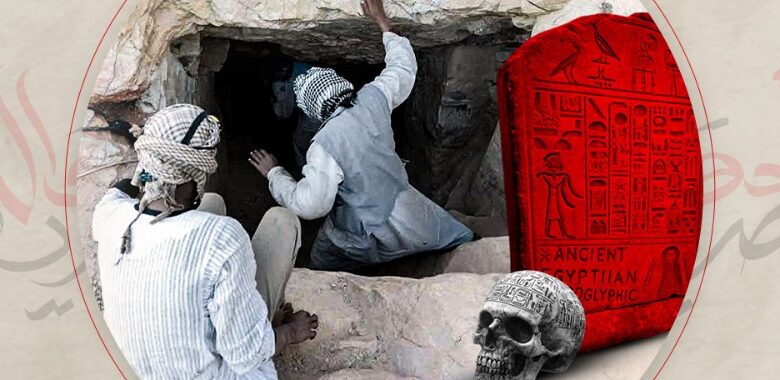في ديسمبر 2024، أعلنت الحكومة تدشين النواة الأولى لمشروع “عودة الكتاتيب”، انطلاقًا من محافظتين في الدلتا هما: كفر الشيخ والمنوفيَّة، ضمن برنا قومي باسم “بداية جديدة لبناء الإنسان”. وفي مايو 2025، عاود مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التأكيد على تبنّي السيسي شخصيًا لهذا المشروع، وهو ما طرح أسئلة جديدة عن الباعث الحقيقي لتلك الفكرة.
تقليص الإنفاق على التعليم
يعاني التعليم في مصر من مشكلات هيكليَّة، إذ تكشف أحدث الإحصاءات أنّ عجز المعلّمين يصل إلى نصف مليون معلِّم، فيما يبلغ العجز في الفصول قرابة 300 ألف فصل، وتقدَّر نسب الأميَّة بحوالي 28% من إجمالي السكان.
ومع العجز في الموارد بفعل توجيه الإيرادات الحكومية إلى سداد أقساط الديون، وتفضيل الحكومة ضخ ما يتبقَّى منها إلى قطاعات بعينها مثل المقاولات؛ نما توجّه عامّ لترقيع تحديات التعليم عبر مقترحات إمَّا أنها لا تكلِّف الدَّولة موارد حقيقيّة، أو تحيل التكلفة إلى الأهالي والمجتمع.
فبدلًا عن إعادة تكليف المعلِّمين بأجور معتبرة لسدِّ العجز، ظهرت مبادرات مثل استقطاب متطوِّعين للتدريس بدون أجر، والعمل بالحصَّة دون تثبيت بمقابل 50 جنيهًا، وإيكال مهمَّة الحدِّ من الأميَّة لطلَّاب الجامعات في سنة التخرّج، فلا يحصل الطالب على شهادته النهائيَّة إلَّا بتقديم ما يفيد قيامه بمحو أميَّة عددٍ من الأفراد.
كذلك جرى اختراع الفصول المتنقِّلة رخيصة الثمن عوضًا عن بناء مدارس جديدة يكلِّف فيها الفصل الواحد نصفَ مليون جنيه، وصولًا إلى تقنين “المساهمات الأهليّة” في تجهيز الفصول، تحت لافتة “المشاركة المجتمعيَّة”. وفي الوقت ذاته، تقدَّر فاتورة “الدروس الخصوصية” بأكثر من 5 آلاف جنيه سنويًا للطالب الواحد.
ما علاقة الكتاتيب بالتعليم؟
تاريخيًا اعتمدت الكتاتيب في جزءٍ من تمويلها على “المساهمات الأهليّة”، فالطالب وأسرته يدفعون مبلغًا رمزيًا للمُعلِّم – الشيخ، وأهل الخير يغدقون عليه من خيرات الريف. وبالتالي، ترفع الدولة عن كاهلها عبء تمويل المعلّمين والمدارس. وتطمح الدَّولة رسميًا إلى تدشين 4500 كُتَّاب خلال الأعوام القادمة.
هندسة الوعي
منذ تولّيه السلطة رسميًا 2013، بدا السيسي شديد الاهتمام بما يسمّيه “تشكيل الوعي” وحماية الإنسان المصريِّ من الأفكار الإثاريّة والهدَّامة وجماعات الشَرّ وترسيخ حالة الاصطفاف مع الدّولة، وعلى ضوء هذا التوجيه السّيادي، توسَّعت برامج الهندسة الاجتماعيَّة مثل “البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة”. وانبثقت مؤسسات رسميَّة لتخريج طلائع شبابيَّة مشبَّعة بخطاب الدَّولة وأدبيّات الاستقرار ومحاربة الإرهاب مثل “الأكاديميّة الوطنيّة للتدريب”.
وامتدَّت برامج الهندسة الاجتماعية من النخب الشبابيَّة إلى الموظِّفين البيروقراطيين، الذين بات يجري تأهيلهم إجباريًا في “الأكاديميَّة العسكريَّة المصريَّة” قبل شغل مناصب في التدريس والدبلوماسيَّة والنّقل والخطابة.
ويأتي إحياء “الكتاتيب” لضمان ديمومة الهندسة الاجتماعيَّة من الصغر، وتحقيقًا لنبوءة الكاتب الرّاحل ياسر رزق الذي اقترح في مقال شهير سابقا تطعيم الأجيال الصغيرة القادمة بقيم “ثورة 30 يونيو” بصورة منهجيَّة رسميَّة حمايةً للدَّولة من تكرار خطر “25 يناير”. وهو ما يتجلّى بوضوح في البيان الحكومي الصادر مع خبر عودة الكتاتيب، عن تعليم الطلّاب “الهويّة الوطنيّة، والوسطيّة، ومواجهة الفكر المتطرِّف”.
الرِّدَّة عن الحداثة والتمسّح في التّقاليد
تعود الكتاتيب تاريخيًا إلى حقبة القرون الوسطى، وهي فترة ازدهار مشهود للحضارة الإسلاميَّة، إلَّا أنّ استعارة الفكرة، بنفس الاسم، من طرف الحكومة تصبّ فعليًا نحو مسعى آخر، لا يتعلّق بالبعث الحضاريّ، بقدر ما يتعلَّق باستلهام قيم سياسيَّة معيَّنة، رجعيَّة، معادية لجوهر الدولة الحديثة.
فإذا كانت الحداثة، بمعناها الإيجابي، تعني – من ضمن ما تعنيه – الحكم المدني، لا العسكريّ، ومساواة المواطنين جميعًا أمام القانون وسيادة الشعب، وتكافؤ الفرص والتقدّم التقنيّ؛ فإنّ قيم النّظام المصريّ الحالي أبعد ما تكون عن ذلك، وقد تخلّفت البلاد عن ركب الحداثة السياسيّة والاجتماعيّة عقودًا، إن لم يكن قرونًا إلى الوراء.
فالحاكم صار “مفوَّضًا” من جموع تخلَّت عن أهليَّتها، يحكم دون قيود باسم الدين والوطنيَّة، ويمتلك زمام كلّ المؤسسات، مُعَسْكِرًا كلَّ القطاعات: “فين المدني اللي هنا؟”. والقانون مُهمَل، لا يطبَّق إلَّا على الفقير والمنبوذين سياسيًا (طائرة زامبيا!)، وحتّى الجانب التقني تدهور بهجرة الأطبّاء وتدنّي الصحّة العامَّة. وباستعادة “الكتاتيب” وما يطرح من أيقونات مثل الألقاب الملكيَّة، توشك أن تتداعى مظاهر الحداثة وروح الجمهوريّة كليًا في مصر.
وفي الوقت ذاته، تأتي فكرة بعث الكتاتيب من الماضي، بما للكتاتيب من جوهر دينيٍّ مقدَّر اجتماعيًا إلى الحاضر في سياق متّصل من استظهار واحتكار نظام الثالث من يوليو في مصر، للقيم المُحافِظة والدّين، لا القيم الحقيقيّة للدين من حكم راشد وعدالة اجتماعيّة؛ وإنما فقط استخدام الدين كأداة للضبط والشرعيَّة.
ومن ذلك، تعمّد السيسي استخدام المفردات الدينيّة في خطابه، والتصوير بـ”السِّبحة”، وبناء المساجد الفخمة، وتوصيف حملات القبض على بعض السّافرات من الطبقة الفقيرة بدعوى “الحفاظ على القيم المجتمعيَّة”. فالظاهر والمطلوب ترويجه هو الاتشاح بثوب الدين، والحقيقة هي قطع الطريق على المعارضين في استخدام الدين للثورة، أو اتهام النظام بمحاربة الدين.
الهوَس بالكيانات الموازية
ويمثل إسناد إدارة الكتاتيب للأوقاف برعاية “أسامة الأزهري” امتدادًا لولع النظام بـ”استحداث مؤسسات موازية” للمؤسسات الرّسميّة التقليديّة لسحب البساط من مؤسسات بيروقراطيّة لا تتماشى مع تطلّعات النّظام.
ففي مصر، ميزانيّة موازية هي موازنة الصناديق السياديّة والخاصّة. ومؤسسات موازية مثل هيئة الشراء الموحَّد وهيئة الدواء والمجلس الصحّي، وهي كيانات مستحدثة لتقليص دور وزارة الصحّة. وحتّى في الكرة، جرى استحداث كيان مواز لاتحاد الكرة الرّسميّ باسم “رابطة المحترفين”.
ويُخطط أن تسحب الكتاتيب الّتي ستديرها الأوقاف قدرًا من رصيد الأزهر في مجال التعليم الدينيّ الأوَّلي، نظرًا للإزعاج الَّذي يسبّبه الأزهر، ومن ورائه هيئة كبار العلماء، للسّلطة في بعض الملفّات السياسيّة والاجتماعيّة. فالمراد هو تعويم الأزهر وسحب صلاحيّاته، لصالح: الأوقاف والإفتاء.
في عام 2014، كرّس قانون “تنظيم الخطابة” ولاية الأوقاف – إلى جانب الأزهر نظريًا – على المساجد والخطابة، وكانت تلك المرحلة الأولى لتخليص الخطابة من المكوِّن غير الرّسميّ وتركيزه في يد الأوقاف خلال وزارة محمد مختار جمعة، حتّى أنّ القانون قد منح بعضاً من موظفي الأوقاف حصرًا حقَّ “الضبطية القضائية”، وفي عام 2020، عُرضَ قانون تنظيم دار الإفتاء، الذي تضمن فصلها عن ولاية الأزهر، ومنحها الاستقلاليّة، وحقّ تخريج مفتين معتمدين لأوَّل مرَّة، وهو ما وصفه الأزهر حينها نصًا بقانون “صناعة كيان موازٍ” في الإفتاء والتعليم الديني.
وصولًا إلى تمرير قانون تنظيم الفتوى مؤخرًا والذي يجعل للأوقاف الولاية على الأزهر في تشكيل “لجان الفتوى” المعتمدة، والتي يعاقب بالسجن من يتجرّأ على الفتوى من خارجها، مع تدشين الكتاتيب وإدارتها من الأوقاف، لتصبح كيانًا موازيًا للمعاهد الأزهريّة الابتدائيّة.