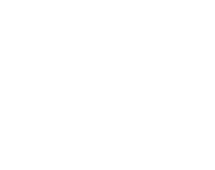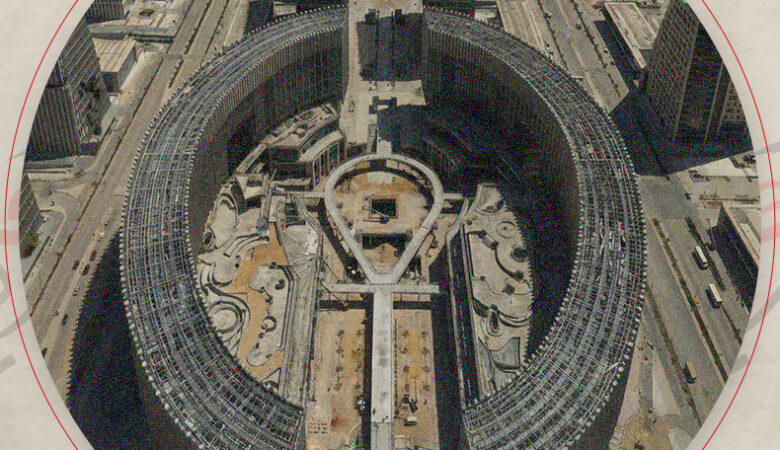بالرغم من أنّ الحكومة تعاني من عجز بأكثر من 300 ألف مقعد معلم في الديوان الحكوميّ، وهجرة مكثفة للأطبَّاء، ومظاهرات من حملة الماجيستير والدكتوراه غير المعينين، فهي لا تعين أحدًا في هيكلها الوظيفيّ إلا بالنذر اليسير. إذ قد أغلقت هذا الباب منذ عام 2014، بل على العكس، تحاول بشتى السبل التخفف من حمولة دولابها البشري. وفي نفس الوقت، يرى بعض الشباب العمل في القطاع الخاص في ظلّ العجز عن تطبيق حدّ أدنى عادل للأجور وانحياز مكتب العمل لربّ المال، ضربًا من العبوديَّة وإفناء العمر بلا عائد. فما العمل إذًا لمن لا تتوافر إليه فرص الهجرة الآمنة من الأجيال الجديدة؟
الإجابة: العمل الحرّ عبر الإنترنت. فرغم عيوبه، حيث يفتقد إلى التغطية التأمينيَّة اجتماعيًا وصحيًا، إلّا أنه في المقابل باب رزق بالنسبة لكثيرين ممن لا يملكون رأس مال لبداية مشروع، فليس على راغب العمل إلا إتقان مهارة وتوفير حاسب شخصي، ومع الوقت ستدور العجلة.
بنية تحتيَّة متهالكة
ماذا يحتاج العمل الحرّ؟ مهارة وحاسوب؟ كان زمان! فالحاسوب، لكي يعمل بكفاءة لا بدّ له من مصدر مستقرّ للتيار الكهربائي وشبكة اتصال دوليَّة سريعة وخفيفة. وقبل أكثر من عام، حاول المستخدمون الضغط على الحكومة لإعادة الاشتراكات الشهريَّة المفتوحة والعدول عن سياسة “الاستخدام العادل” (الباقات)، إذ لا يليق في عصر الإنترنت والجودة البصرية الفائقة أن تتقاسم الأسرة المكونة من 4 أفراد كحدٍ أدنى باقة إنترنت محدودة شهريًا بسعة 140 جيجابايت (الباقة الأكثر شيوعًا).
فكان ردّ الحكومة حاسمًا، اعتقال الداعين إلى تلك الحملة، وقصر مفهوم تطوير الإنترنت على السرعة لا السعة، بالرغم من أنَّ المستخدمين لم يشتكوا من السرعات، فضلا عن حديث الحكومة بشكل متكرر عن سوء استخدام المواطنين للإنترنت غير المحدود عبر الوصلات غير الشرعيَّة التي تؤثر سلبًا على دخل الحكومة من مرفق الإنترنت.
ما زاد الطين بلَّةً، هي مشكلة تخفيف الأحمال، فبشكل مفاجئ بات المستخدم يجد كلَّ الأجهزة التي تعمل بالكهرباء، وعلى رأسها الحاسوب والإنترنت، خارج الخدمة يوميًا لساعتين على الأقلّ، مع تباين مدد تخفيف الأحمال بين المدن والريف، الأمر الَّذي أضرَّ بأرزاق مستخدمي الإنترنت في العمل عن بعد.
أحد أبرز المقاطع شيوعًا، كان فيديو وثَّقه شابٌ يعمل بشكل حر عبر النت بما يدرّ دخلاً دولاريًا على البلاد، حيث أشار إلى أنه صار عاجزًا عن الرد على تساؤلات مسؤوليه الأجانب الذين يقترحون عليه البحث عن أماكن مستقرة التيَّار لتنفيذ الأعمال، غير أنهم لا يعلمون أنّ الكهرباء تخرج عن الخدمة في عموم البلاد بالتناوب، فلا مفرّ!
ضرائب بالكوم
منذ صيف 2022، تفتَّق ذهن الحكومة عن ضرورة تعميم الضرائب على العاملين عبر الإنترنت، ما طرح حينها تساؤلاتٍ عن عدالة تلك الضريبة، إذا كان “الفريلانسر” يدفع تكلفة إيجار شقته التي يسكنها ويسدد شهريًا – بلا دعم – فاتورة الكهرباء والإنترنت، ويعمل من خلال حاسوبه الشخصي، ولا يتمتَّع بأي مظلَّة تأمينيَّة حكوميَّة.
توجد 3 قوانين ضريبيَّة مختلفة يخضع لها العاملون عبر الإنترنت، هي قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020. ويستوي في ذلك صنَّاع المحتوى (البلوجرز والمدوَّنون) والعاملون في التجارة الإلكترونيَّة والبيع وتقديم الخدمات الاستشاريَّة، وحتَّى مقدمو الخدمات الافتراضيَّة، طالما أنهم يدرّون دخلًا، الأمر الَّذي دفع بعض المشاهير إلى مغادرة البلاد والبثّ من مدن عربيَّة مجاورة تتمتع بأنظمة ضريبيَّة أفضل، فيما لجأ آخرون إلى محاولة فتح حسابات بنكيَّة وهميَّة خارج البلاد.
في يوليو 2023، بدأت الشركات التكنولوجية العالمية العاملة في مصر، مثل جوجل وفيسبوك وسناب شات، إخطار عملائها في الداخل بالانخراط في خطة الحكومة المصريَّة لتحصيل ضريبة القيمة المضافة بمقدار 14% من الأفراد على كلّ خدمة مدفوعة يحصلون عليها.
وقف البطاقات
نهاية 2022، أصدرت معظم البنوك الكبرى العاملة في مصر قرارًا صادمًا لعملائها بتخفيض الحدّ الأدنى لعمليات الدفع الدوليَّة على أكثر البطاقات شيوعًا، والتي يُستخدم بعضها في دفع الكورسات وإيجارات المواقع وشراء تذاكر الطيران، لما يعادل حوالي 100 دولار شهريًا فقط، مع رفع رسوم تدبير العملة إلى 13% تقريبا. وهو نفس الشهر الذي وثقت فيه الفتيات العاملات في مجال استيراد الملابس من الخارج بالاستفادة من ثغرات النظام الجمركيّ الذي يسمح بشحن المتعلقات الشخصيَّة بلا رسوم تقريبًا، لإعادة بيعها داخليًا وتوفير مصدر دخل لهنّ، قيام ميناء سفاجا بإتلاف ومصادرة حوالي 45 ألف قطعة من العلامة التجاريَّة العالميَّة (شي إن).
وفي يونيو 2023، أصدر البنك المركزي قرارًا بوقف “البطاقات مسبقة الدفع” في عمليَّات الدفع الدوليَّة بالعملة الصعبة، لا مجرد التضييق على الحدّ المسموح ورفع الرسوم كما حدث سابقًا، والبالغ عددها حوالي 25 مليون بطاقة، ما مثّل ضربةً لشريحة من العاملين في مجال “التسويق الإلكتروني” – صناع الإعلانات الممولة ممن كانوا يستخدموا هذه البطاقات لدفع قيمة الإعلانات للشركات العالميَّة.