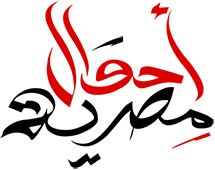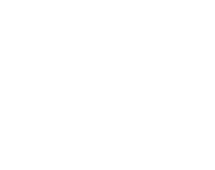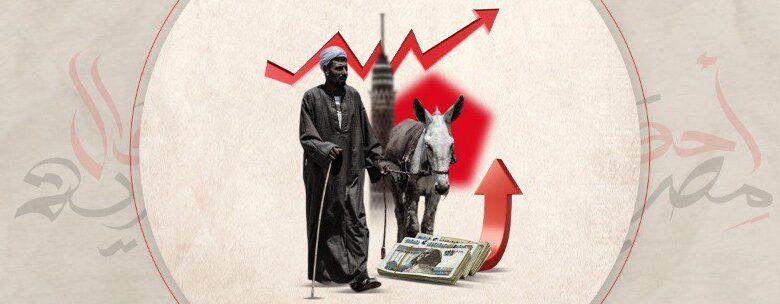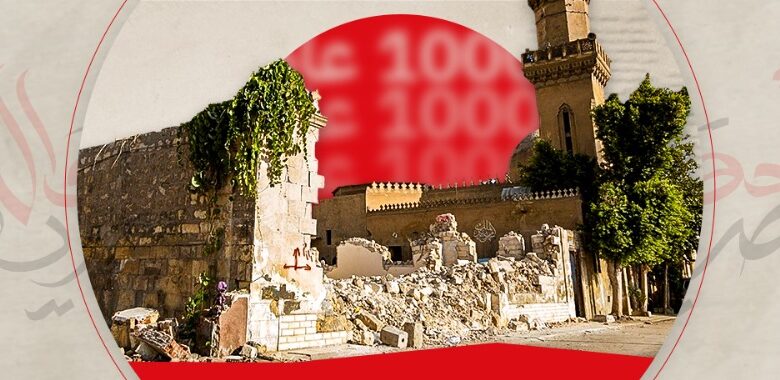في حفل استثنائي بالإنجاز الأكبر لبلدهم في العقد الأخيرـ افتتح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد السدّ الذي طالما هدّد بجفاف النيل. وفي القاهرة، صدرت بيانات حكومية تدين الخطوات المنفردة لأديس أبابا، تتمسك دائما بعبارة: «نحن حريصون على حقوقنا التاريخية».
المشهد يختصر عقداً من التراجع المصري سياسيا ودبلومسيا؛ فبينما كانت إثيوبيا تُعلن «مشروع القرن» وتُحول سدها إلى رمز وطني، كانت مصر تُعلن «الالتزام بالمفاوضات»، حتى صارت تُفاوَض وهي تُراقب النهر يُغلق أمامها بوابةً تلو أخرى. هذا التناقض الصارخ بين خطاب الفعل وخطاب الترقب، هو ما شكل الفجوة التي استثمرتها إثيوبيا في طريقها إلى السيطرة على مصدر الحياة لمصر.
من «الفيتو» التاريخي إلى «إعلان الخرطوم»
لم تكن فكرة السدّ سرّاً. فمنذ التسعينيات، حذّرت تقارير المخابرات المصرية من أن إثيوبيا تُعدّ «للنيل الأزرق سداً يُعادل خزان أسوان». لكن القاهرة كانت وقتها لا تزال تمتلك «فيتو» سياسياً ودبلوماسياً قوياً، مدعوماً باتفاقيات تاريخية مثل اتفاقيتي 1929 و1959 اللتين تمنحان مصر حق «الاعتراض» على أي مشروع مائي في دول المنبع. كانت مصر تلوّح بالمجتمع الدولي، وتُذكّر الجميع بأن «النيل خط أحمر».
حتى جاء عام 2015، فوقع الرئيس عبد الفتاح السيسي (إعلان مبادئ الخرطوم) مع رئيس وزراء إثيوبيا والرئيس السوداني السابق عمر البشير.
في تلك اللحظة، تخلّت مصر عن “الرفض المطلق” واقتنعت بـ”وعود التعاون”، مما منح إثيوبيا أول اعتراف قانوني ودولي بمشروعها، وصعب التقاضي الدولي على مصر، التي منحت ورقة على بياض مستندة إلى حسن النوايا لدى الحبشة.
فبينما وعدت الحكومة المصرية الشعب بأن إعلان المبادئ الذي تم توقيعه عام 2015، لن يؤثر على حصة مصر من المياه ذات الــ (55.5 مليار متر مكعب)، كانت النتيجة أن إثيوبيا حصلت على غطاء قانوني يُسهّل التمويل من مؤسسات دولية وصينية، بينما خرجت مصر من الاجتماع بلا ضمانات ملزمة، بل وخرجت من حقها في الفيتو التاريخي. يرى خبراء أن هذه الخطوة شكلت تنازلاً عن مبادئ أساسية مثل “الإجماع، والإخطار المسبق، وعدم الضرر” التي ترفضها إثيوبيا.
“والله والله لن نضر مصر“.. الأزمة تتحول إلى «مسرحية»
في 2018، وقف الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى جوار آبي أحمد في قصر الاتحادية، وقال أمام الكاميرات: «قول ورايا والله والله لن نضر مصر في المياه». ردّ آبي أحمد مبتسماً: «والله والله». تبادلا القَسَم، ثم عادت أديس أبابا لتُسرّع في بناء السدّ، وعادت القاهرة تُصدر بيانات «القلق». هذا المشهد، الذي لا يُنسى، تحوّل إلى مادة ساخرة في الإعلام العالمي، فبينما كانت إثيوبيا تعمل على الأرض، كانت مصر ترهن مصيرها المائي بكلمة عابرة أمام الكاميرات. هذا الحدث لم يوضح فقط غياب الجدية في التعامل مع الأزمة، بل حولها إلى «مسلسل بروتوكولي» لا يملك حلقاته نهاية، مما أضرّ بمكانة مصر التاريخية في إدارة ملف المياه.
حين فقدت مصر آخر أوراق الضغط الدبلوماسي
بعد إعلان الخرطوم، حاولت القاهرة التلويح بالخيارات الدولية. ذهبت إلى الاتحاد الإفريقي فسمعها شعار «حلول إفريقية» الذي يفضل إثيوبيا، وطرقت باب واشنطن فتوسط ترامب، ثم انسحبت إثيوبيا من التوقيع في اللحظة الأخيرة، في رسالة واضحة بعدم التزامها بأي اتفاق لا يخدم مصالحها. ارتفعت الأصوات في مجلس الأمن، لكن الملف صُنّف «خلافاً فنياً» لا يستحق الفصل السابع. وفي كل مرة كانت إثيوبيا تعلن عن مرحلة جديدة في الملء، كانت مصر تعلن عن «جولة جديدة من المفاوضات». هذا المسار كشف عن العزلة الدبلوماسية التي وجدت مصر نفسها فيها، بعد أن كانت تملك حقاً تاريخياً في التحكم في مصير النيل.
يؤكد خبراء أن إثيوبيا تسعى بشكل متعمد لجر بقية دول حوض النيل إلى القضية، رغم أن جميع الاتفاقيات التاريخية حصرتها بين الدول الثلاث. كما أن الموقف المصري يستند إلى رفض “اتفاقية عنتيبي” الموقعة عام 2010 والتي دخلت حيز التنفيذ في سبتمبر 2024، والتي تسمح لدول المنبع بتنفيذ مشاريع دون التوافق مع دولتي المصب، وتستخدمها أديس أبابا كأداة تحريض.
أرقام صادمة,, مصر تواجه الخطر
الأرقام تقول إن 93% من أراضي مصر صحراء، وأن 100 مليون مصري يشربون من النيل فقط، لكن القرار السياسي كان أقرب إلى «الانتظار» منه إلى «التحرّك». وبمجرد اكتمال الملء، فقدت مصر ورقتها التفاوضية الوحيدة المتبقية وهي “إيقاف الملء”.
الأضرار المباشرة للسد تتمثل في استقطاع 15 مليار متر مكعب من حصة مصر والسودان سنويًا، بالإضافة إلى مخاطر محتملة على سلامته. ففي حالة انهيار السد، قد تغمر المياه بحيرة السد العالي، وقد يغمر ما يقرب من 24 ألف كيلومتر مربع من الأراضي الزراعية على طول المساحة بين السدّين.
وبعيداً عن السد الإثيوبي، الذي راكم مشكلة المياه وزادها خطورة، فإن أزمة مصر بدأت منذ فترة طويلة. فالنيل الذي كان مصدراً لا ينضب للحياة، أصبح اليوم بالكاد يصل إلى البحر المتوسط. وبمرور السنين وزيارة أعداد السكان في مصر بشكل كبير أصبح احتياج المصريين إلى المياه يتضاعف. فبين عامي 1960 و2020، تضخم عدد سكان مصر من 27 مليوناً إلى أكثر من 100 مليون نسمة، مما أدى إلى انخفاض نصيب الفرد من المياه إلى الربع. وبحلول عام 2025، يُقدَّر أن ينخفض نصيب الفرد من المياه إلى ما دون 500 متر مكعب، وهو مستوى يُعرف بـ “الندرة المطلقة”.
على الجانب الآخر، يُشكل قطاع الزراعة في مصر 11% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه يوظف حوالي ربع السكان، ويعتمد عليه حوالي نصف السكان في معيشتهم. ورغم أهميته، يستهلك هذا القطاع 86% من إجمالي المياه العذبة التي تُسحب من النيل. هذا الواقع يضع قيوداً على الإنتاج الزراعي وقدرة القطاع على توفير الدخل المستدام. وفي ظل التزايد السكاني ونقص المياه، من المحتمل أن يزداد عدد الفقراء في الريف، والذين سيعانون بشكل مباشر من قلة فرص العمل وتدهور الأوضاع المعيشية.
وبالإضافة إلى ذلك، سيزيد انخفاض نصيب الفرد من المياه من المخاطر المتعلقة بالأمن الغذائي. فمصر، التي كانت في يوم من الأيام “سلة خبز” الإمبراطورية الرومانية، تستورد الآن حوالي 40% من استهلاكها الغذائي، مما يجعلها واحدة من أكثر الدول اعتماداً على واردات الغذاء في العالم. وقد يؤدي أي نقص في إمدادات المياه إلى انخفاض الإنتاج الزراعي المحلي، خاصة للزراعات كثيفة الاستهلاك للمياه مثل الأرز وقصب السكر، مما يجعل مصر أكثر عرضة لتقلبات أسعار الغذاء العالمية لهذه اسلع الاستراتيجية، وهو ما قد يتسبب في نقص حاد في المواد الغذائية وارتفاع أسعارها بشكل كبير.
ماذا بعد أن صار السدّ واقعاً؟
يقول خبراء المياه إن الخيار الوحيد المتبقي هو إدارة الأزمة لا حلّها: ترشيد الري، والتوسع في محطات تحلية المياه، والبحث عن مصادر بديلة. أما على المستوى السياسي، فثمة من يطالب بمراجعة شاملة لما حدث: كيف سُلمت «ورقة الرفض» في 2015؟ ولماذا لم تُحضّر القاهرة بديلاً عن المفاوضات؟ ومن يتحمّل مسؤولية تحوّل مصر من «صاحبة الفيتو» إلى «متفرّج»؟
ووفقا للقوانين والأعراف الدولية، لا تزال مصر تتمتع بغطاء دولي واسع، وتُبقي على خيار العودة إلى مجلس الأمن قائماً، سواء عبر الفصل السادس أو الفصل السابع الذي يوفر إجراءات قد تصل إلى التدخل العسكري، ولكن هل تقوم مصر بضرب السد بعد أن بلغ منتهاه وصار أمرًا واقعا؟
بين هذا وذاك، يظل النهر يجري، لكن بوابات السدّ الحبشي أصبحت هي من تُحدّد سرعته. ويبقى السؤال معلقاً: هل ستكتفي مصر بمحطات التحلية وبيانات «القلق»؟ أم أن هناك من يُعدّ خطة لاستعادة الورقة المفقودة قبل أن يتحوّل «القَسَم» إلى آخر ما تبقى من ماء؟