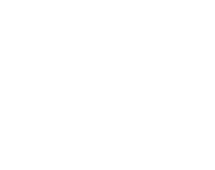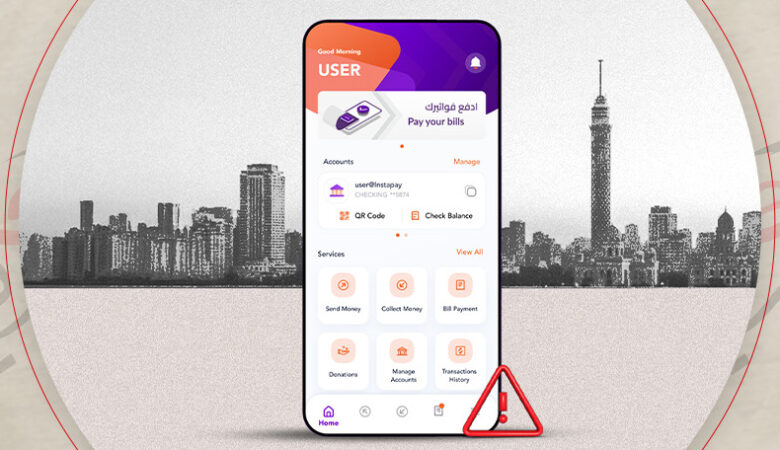لا يكاد يمر يوم أو يومين إلا وتسمع في قريتك أو يتم تداول مشاهد ترنح متعاطي المخدرات في وسائل التواصل الاجتماعي، ظاهرة أصبحت انتشارها أمرًا لا يمكن إنكاره، ففي مقطع الفيديو الذي ظهر فيه سائق حافلة نقل عام في المطرية وهو يترنح بسبب تعاطيه المخدرات مما كان أن يعرضه مع الركاب لخطر كبير، سبقه مشهد آخر لسائق توكتوك وهو يقوم بتوزيع المخدرات على الناس علنا في شبرا الخيمة. أما المشهد الأكثر رعبًا، فكان لشباب فقدوا الوعي وتملكت منهم نوبات التشنج في منتصف الطريق بعد تعاطي مخدّرات، وأصبح المشهد كـ”زومبي” خرج إلى واقعنا من أفلام الرعب.
هذه الوقائع التي تجري في وضح النهار تكشف مدى خطورة الظاهرة على حياة المواطنين، وتطرح تساؤلات مريرة حول أسباب تفشيها وغياب الرادع الحقيقي لها.
الأرقام الرسمية ـ والتي لا تعكس الواقع بالضرورة ـ تؤكد أن الأزمة كبيرة. صندوق مكافحة الإدمان أعلن في آخر مسح وطني في فبراير 2019، أن حوالي 5.9% من المصريين يتعاطون أنواعا متعددة من المخدرات، يعني تقريبًا 6 من كل 100 مواطن مصري، فماذا عن الرقم الحقيقي الذي هو بالطبع أكبر من هذا بكثير.
وفي أحد اللقاءات التي ظهر فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ذكر أن المخدرات التي ضُبطت في سنة واحدة وصلت قيمتها 8 مليارات جنيه. رقم ضخم يوضح أن تجارة السموم صارت اقتصاد موازٍ شغال في الخفاء، يغذي العنف والفساد وبيستنزف المجتمع.
الأمر لم يقتصر على نوع واحد مثل الحشيش. فالترامادول، الهيروين، والأقراص المصنعة مثل الاستروكس والشابو أصبحوا منتشرين بقوة. بيانات الخط الساخن تقول إن أكتر من نصف من طلب العلاج في 2021 كانوا مدمنين حشيش، يليهم الهيروين والترامادول. يعني المشهد يتغير من “كيف” تقليدي، إلى مواد كيميائية تخليقية أخطر على الصحة وأرخص سعرا، تضرب الشباب في صحتهم وعقولهم.
الخطورة ليست في الأرقام فقط، وأغلب المتعاطين ضحايا أكثر منهم جناة، لأن هناك علاقة المباشرة بين السقوط في المخدرات والبطالة. فتقارير صندوق الإدمان سنة 2022 تقول إن 62% من المتقدمين للعلاج كانوا عاطلين عن العمل.
يبدو ذلك منطقيا: شاب فاقد الأمل في شغل أو مستقبل، يلجأ للمخدر كمهرب أو يدخل تجارة صغيرة يوزع فيها السموم في الحارة. كأن المخدرات بقت “مخدر للألم الجماعي”.
ورغم أن وزارة الداخلية تعلن عن ضبطيات ضخمة، لكن الأرقام تقول إن المشكلة أكبر من كل الكميات التي يتم ضبطها. في سنة 2022 وحدها، تم تسجيل حوالي 94 ألف قضية مخدرات، وضبط 347 طن بانجو و29 طن حشيش و3.4 طن هيروين وحوالي 23 مليون قرص مخدر.
هذه بالتأكيد كميات مهولة، ومع ذلك السوق لسه شغال والشارع لسه مليان.
النتيجة الطبيعية إن الأسر نفسها أصبحت الضحية الأولى. أم تبيع ذهبها لتدخل ابنها مصحة، أب سيستفيق ابنه بيبع أثاث البيت عشان يجيب جرعة، أو جرائم بشعة يرتكبها شباب تحت تأثير “الشابو” أو غيره من المخدرات المستحدثة.
في حادثة مرعبة في الصعيد السنة الماضية، شاب قتل جاره وفصل راسه تحت تأثير المخدر. هذه ليست حالة استثنائية، لكنها مثال يكشف لأي درجة يمكن للمخدرات أن تحوّل الإنسان إلى وحش فاقد للسيطرة.
في المقابل، الحكومة اتبعت أحيانًا أسلوب عقابي أكتر منه علاجي. قانون فصل الموظفين المتعاطين سنة 2019 مثال: فُصل مئات الموظفين من أعمالهم من دون توفير علاج أو برامج لإعادة التأهيل. قد تكون هذه الخطوة رادعة، لكنها لم تُعالج أصل المشكلة؛ بل تدفع كثيرًا من المُتعاطين إلى التخفي أو فقدان مصدر رزقهم والتورط أعمق في دائرة التعاطي.
الأزمة تكمن بوضوح في أنه، رغم كثرة الحملات الأمنية والكشف المفاجئ، ما زالت السياسات تتحرك في إطار ردّ الفعل لا العلاج من الجذور. لا نرى خطة طويلة المدى تجمع التعليم والصحة والعمل والتنمية في مسار واحد واضح، ولا توجد شفافية منذ توقف صدور أي مسح قومي دوريًّ يحدّث الأرقام ويقيس الأثر. كما أن تمويل الوقاية في المدارس والجامعات محدود، وبرامج الحد من الأضرار شبه غائبة، فتظل الجهود موسمية ومرتبطة بالضجيج الإعلامي أكثر من ارتباطها بنتائج مستدامة.
لا يمكن إحداث اختراق في الحرب على المخدرات من دون مسار متكامل للعلاج وإعادة التأهيل والدمج. وتوفير خدمات الصحة النفسية والإدمان بشكل آمن ومجاني، بل إن المؤسسات العلاجية التي توفرها الدولة، محدودة، وتعاني من الانتظار طويل، والتغطية غير عادلة بين المحافظات. ولا تتوافر حوافز كافية لتوظيف المتعافين، ولا شبكة سريعة ومجانية وسرّية للعلاج في كل مكان. بهذه الفجوات، تبقى المخدرات نتيجة طبيعية لمعادلة معروفة: تعليم متراجع، بطالة مرتفعة، فقر واسع، وشبكات دعم ضعيفة، وكل هذا لا تُعالجه الحملات الأمنية وحدها، في اختبار لم تنجح فيه الحكومة بعد.