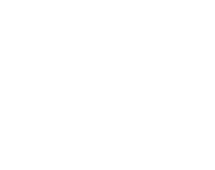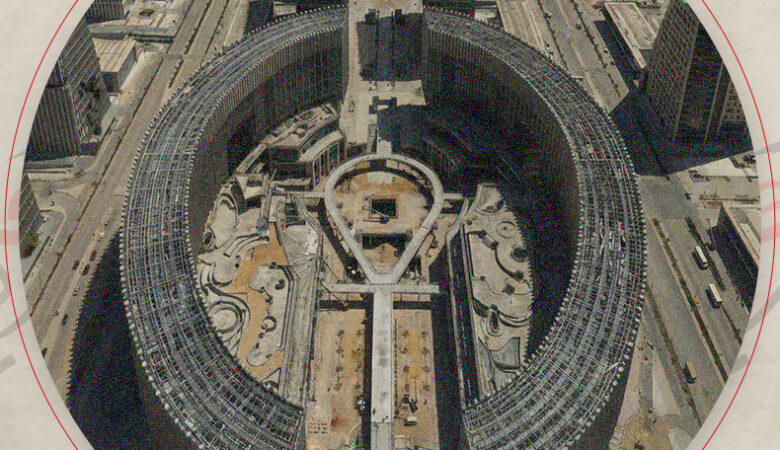منذ أيام معدودة أعلنت الحكومة، في أكبر خطوة من نوعها، عن خطة لطرح 40 مستشفى عام أمام القطاع الخاص، في عدد من المحافظات، من بينها مستشفي في القاهرة والصعيد والدلتا. وتعكس الخطة، التي تمتد على فترة عشر سنوات، اتجاهًا متسارعًا نحو خصخصة خدمات حيوية مثل الصحة، وسط تساؤلات عن
مصير الفقراء وحقهم في العلاج.
وبموجب قانون جديد يحمل اسم “منح التزام المرافق الصحية”، أصبح للقطاع الخاص الحق في إدارة وتشغيل المستشفيات العامة. وقد بدأ التنفيذ فعليًا من خلال شراكة لتطوير مستشفى دار السلام وتحويله إلى مستشفى “جوستاف روسيه الدولي – مصر”، لكن التجربة أثارت جدلًا بعد شكاوى من تأخر العلاج مما دفع السلطات لفتح تحقيق.
تقول الحكومة إن الشراكة تهدف لتحسين جودة الخدمة، لكن التجارب السابقة في قطاعات كالكهرباء والتعليم تثير مخاوف واسعة، خاصة في بلد يُقدّر فيه أن 62% من الإنفاق الصحي يأتي مباشرة من جيوب المواطنين، ونحو 40 مليون مصري يعيشون خارج منظومة التأمين الصحي إذ يستفيد منه 70 مليون من أصل 110 مليون مواطن، حسب تقديرات رسمية. في ظل هذه الأرقام، قد تتحول الخصخصة من فرصة لتحسين البنية التحتية إلى خطر يهدد العدالة الصحية.
هل القطاع الخاص هو الحل؟
لسنوات، لم تلتزم الدولة حتى بالحد الأدنى من الإنفاق الدستوري على الصحة. فبينما ينص الدستور المصري على تخصيص ما لا يقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي لهذا القطاع، لم تتجاوز النسبة الفعلية في موازنة 2024/2025 حاجز 1.16%.
هذا العجز المزمن في التمويل لم يمر دون أثر، إذ انعكس على تهالك البنية التحتية للمستشفيات، وضعف الإمكانيات، وهروب آلاف الأطباء إلى الخارج بحثًا عن ظروف أكثر إنسانية. وعلى الجانب الآخر، يتحمّل المواطن العبء الأكبر، إذ تشير التقديرات إلى أن أكثر من نصف الإنفاق الصحي في مصر يأتي مباشرة من جيوب المرضى، في ظل تراجع الدعم الحكومي وغياب مظلة تأمين صحي شاملة.
وحين بلغ الانهيار مداه، لم تكن استجابة الدولة بضخ استثمارات عامة أو إعادة هيكلة حقيقية للقطاع، بل بخطوة واحدة: فتح الباب على مصراعيه أمام القطاع الخاص ليتولى ما عجزت الدولة عن إصلاحه. هكذا وجد المواطن البسيط نفسه، من دون حماية أو دعم، في مواجهة مباشرة مع سوق استثماري لا يعترف إلا بمن يملك القدرة على الدفع.
هل يهاجر المواطن بعد الطبيب؟
الإلقاء بالقطاع الصحي في حجر القطاع الخاص يأتي في وقت تزداد فيه أعداد الأطباء المغادرين. فبين عامي 2019 و2022، قدّم أكثر من 11 ألف طبيب استقالتهم من القطاع الحكومي. ووفق نقابة الأطباء، يعمل أكثر من 120 ألف طبيب مصري بالخارج، مقابل أقل من 93 ألفًا بالداخل، ما يعني أن أكثر من نصف الكفاءات اختارت الرحيل. السبب لا يقتصر على ضعف الأجور رغم أهميته، بل يشمل أيضا غياب بيئة آمنة، وتكرار وقائع الاعتداء على الأطباء.
ومع تدهور الأوضاع داخل المستشفيات العامة، وانخفاض عدد الأسرة إلى 1.4 سرير فقط لكل 1000 مواطن (مقارنة بـ2.9 عالميًا)، تزداد الفجوة بين الطبقات. المواطن الفقير إما يُترك لطابور الانتظار، أو يُجبر على الاستدانة للذهاب إلى مستشفى خاص. ومع دخول مستشفيات الدولة نفسها إلى حيز التشغيل الربحي، تصبح المعادلة أكثر تعقيدًا.
تراهن الحكومة على ما تسميه “الشراكة المستدامة” مع القطاع الخاص، وتقول إنها ستمنح المستثمرين “الرخصة الذهبية” لتسريع الإجراءات، في مقابل التزام بعدم المساس بحقوق المرضى. لكن الواقع يفرض طرح أسئلة أبعد من الأرقام: من يضمن العدالة في توزيع الخدمة؟ ومن يراقب الأسعار؟
الصحة، كما التعليم، ليست ترفًا اقتصاديًا، بل ركيزة للاستقرار الاجتماعي. والخصخصة، إن لم تكن مصحوبة بحماية صارمة لحقوق الفقراء، قد تُحسِّن الشكل وتُفاقم الألم. وفي بلد يصنَّف ينفق مليارات الجنيهات على بناء الطرق والمدن الجديدة، تبدو مفارقة قاسية أن يُعاد تشكيل منظومة الصحة وفق منطق السوق، بينما يُترك الإنسان ليواجه المرض وحده، دون دعم حقيقي أو ضمانات حاسمة.
أضف تعليقك